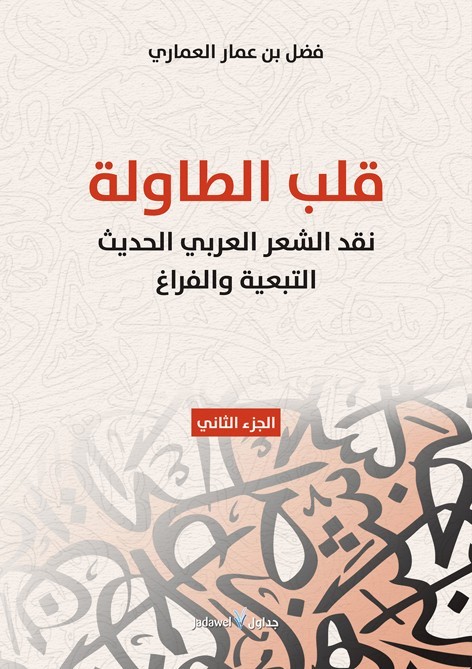كانت اللغة العربية في العصريْن؛ الجاهلي والإسلامي سليقةً وطبعًا هي لغة الشعر. وفي العصر العباسي صارت مُدارسةً وحفظًا، فهناك اللغة الأدبية وهناك اللهجات، وكلُّ ذلك شعر نظمًا ونقدًا. ولما جاء العصر الحديث سار الشعراءُ مسيرة مَن سبقهم، فصلًا بين اللغة التي يتخصَّصون فيها «الفصحى» واللغات المحلية في بيئاتهم، فلم يتحقق الشرط الأساس في كل الشعر العالمي، وهو «الطبع» و«السليقة». ولكن النقَّاد راحوا يُطبِّقون مناهج النقد الغربي على ما لا يصلح له، حتى وصلنا إلى «الشعر الحر»، الذي التزم بالإيقاع، لتحقيق الغنائية. وتراكمت الدراسات، فإذا بنا أخيرًا ننسف كل ما سبق لنصل إلى «النثيرة». وتبوّأ أدونيس قمة الشعر والنقد، إن لم نكن الآن في مرحلة «الشعر النصي»! يأتي هذا الكتاب، بأجزائه الثلاثة، ليخلُص إلى أن فاقد الشيء لا يعطيه، فمنذ أبي نواس، ونحن نقرأ شعرًا، وبما حقّق النغم والنظم، ولكنه افتقر إلى العطاء التلقائي والعفوية في لغة يتدَّرج فيها، لغته الأُم، وليس اللغة التي يلجأ إليها عندما يريد قول الشعر. فليكن هنالك شعر، تعبير ذاتي، يفتقر إلى العبقرية؛ وغالبًا ما كان أسير عصره، ولنكفّ عن نقده، وبرفق، فلنقلب الطاولة.
Share message here, إقرأ المزيد
قلب الطاولة : النقد العربي بين المعيارية والوصفية