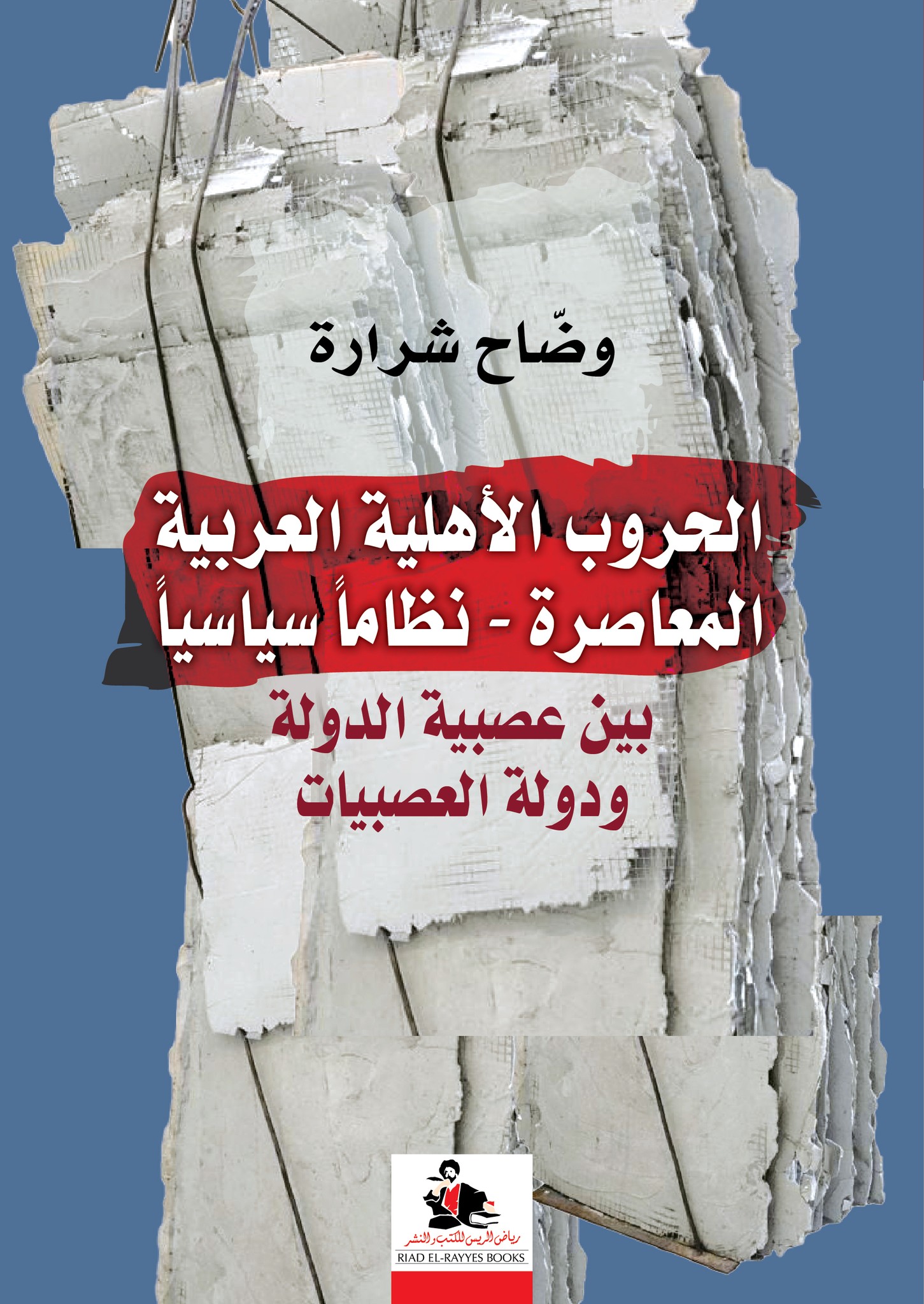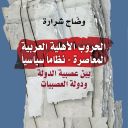تتحدر الجماعات الأهلية- السياسية المشرقية، الشرق أوسطية، والبلدان التي تضويها، من تاريخين: الأول، إمبراطوري وسلطاني مديد، هيمنت شريعة الإسلام على مجتمعاته ومعتقداته وسنن أهله وروابطهم. وتولت في الأثناء أقوام من المسلمين حكم بلدان الفتوح باسم الدين والشريعة، وباسم حق السيف والفتح والغلبة. والتاريخ الآخر، محدث ومعاصر، أوروبي فاتح، استعماري ورأسمالي، جدد عنوة تنظيم هذه المجتمعات على افتراض معايير: المساواة والفردية وتحكيم ما يراه فهم الفرد (على خلاف الجميعية المرتبية وتقليد السلف)، والنفعية الحسابية والتراكمية (على خلاف ما تقضي به السنن الثابتة والقيم المحافظة)، والتاريخ (على وجه تجديد صور الاجتماع وابتكار المعاني والمعارف والقيم وتحويرها)، والتعاقد على هذا التجديد وعلى إقرار ما لا يتطاول إليه ويتناوله.
وحفظت المجتمعات المشرقية من نسبها الأول دمج السياسة، وعلاقاتها ومنازعاتها، في حرب أهلية كثيرة الفصول والمسارح، ولكنها متصلة. وقطباها، الدولة، على معنى القوة الحاكمة وأهل هذه القوة أو عصبيتها، و"المجتمع"، على معنى الجماعات المحكومة. والعصبية الواحدة التي قد تجمع "أهل الضعف" في حلف وفي مقابلة عصبية الدولة ونظيرها.
وطبع التاريخ الإمبراطوري، القومي والديني (الإسلامي) الطويل والراسخ، السياسة وصورها في الذاكرات والانفعالات والأذهان، بطابعه. فعجزت الجماعات عن تصور اجتماعها السياسي، والوصلة بينها وبين الجماعات الأخرى القريبة، على غير شاكلة المثال الإمبراطوري هذا.
وعندما بادرت الجماعات إلى تعريف هويتها السياسية، في إطار الدولة الوطنية الجديدة والمنزلة من خارج، عالجت الجماعات من طريق النسب الإمبراطوري- السحيق زمناً، والعريض مساحة واللجب عدداً، والمهيب جبروتاً- وراثتها بلداناً – دولاً ضيقة لا حول لها ومتناثرة التركيب، ووُلدت فعلاً من الشتوة الأخيرة.
وأسهم التاريخ الآخر في ولادة مجتمعات فاقم تنافرها وتبعيتها. فنمت على هامش العلاقات الرأسمالية فئات طفيلية وريعية هزيلة، ينتمي معظمها إلى الأقليات، وتفتقر إلى مقومات الدالة والمرتبة السياسيتين المحليتين، وإلى مؤهلات الجمع والقيادة والإقناع. وقصر القطبان، القطب الإسلامي والسلفي والقطب العصري و"الدهري" ( الدنيوي والزمني)، عن قيادة المجتمع قيادة جامعة. فترجحت المجتمعات، بهذه الحال، بين قيادتين قاصرتين، وأسلمت زمامها إلى أجهزة القوة، الجيش والدرك والاستخبارات والقوات الخاصة، لتتولى الحكم بديلاً من طاقم سياسي يعصى الولادة والاستواء مكتمل الخلق وسوياً.
وتتوج الحرب الأهلية، المستترة والدابة أو العلنية، أمرين حيويين: إيجاب النزاع في صورة صراع حاسم وأخير بين حقيقة "الشعب" العميقة والواحدة وبين واقعه الماثل المجزأ والركيك، من وجه، وتسويغ إعمال العنف والجموح به إلى أقاصي الاستئصال و التهجير على المثال الإسرائيلي. فالحروب الأهلية، على خلاف الحرب بين الدول، تجيز عرفاً سعي كلا القطبين في استواء الشعب الواحد كله، ونفي الشطر الآخر نفياً مادياً. وتتستر المقالات في "المكونات" و"تمثيل التنوع"، على إرادة توحيدٍ لا تتورع عن القتل والإبادة، المتخيلين قبل الإعمال. وتتسلط هذه الإرادة، على المواردـ وتوزعها التوزيع المتفاوت والفاسد الذي أثار حراكات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.